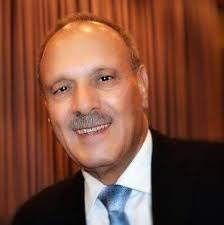جاء الحق وزهق الباطل

جاء الحق وزهق الباطل
حين صمت السيف وتكلّم الوحي
بسم الله الرحمن الرحيم
في صحراءٍ ممتدةٍ كالصبر،
تسير القوافل نحو مكة بخطى متعبةٍ ولكن بقلوبٍ لا تعرف الانكسار.
لم يخرجوا لحربٍ، بل لعُمرةٍ وسلام،
لكن الطريق الذي سلكوه لم يكن مفروشًا بالنصر، بل بالاختبار.
وقف النبي ﷺ وصحبه على مشارف الحديبية،
تغمر وجوههم غبرة السفر ولهيب الشمس.
كانوا يرون في العودة بلا عمرة هزيمة،
وفي السكوت عن القتال ضعفًا،
لكن القائد الهادي كان يرى ما لا يرونه،
ويصغي إلى ما لا يسمعونه.
اقترب عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وفي صوته حميّة الإيمان وغيرة الرجال:
“يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟
فلمَ نعطي الدنيّة في ديننا؟ ألسنا المؤمنين وهم الكافرون؟”
فقال النبي ﷺ بثقة الواثق بربه:
“يا عمر، إني رسول الله، ولن يضيعني ربي أبدًا.”
ثم جاءت لحظة التوقيع،
حين جلس سهيل بن عمرو، مفاوض قريش،
ورفع صوته بنبرةٍ فيها كبرياء المنتصر وظنّ المتحكّم:
“اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشًا.”
تغيّرت الوجوه، وغلى الصدر بالغيرة،
كأنّ كل حرفٍ في الوثيقة سهمٌ في القلب.
لكن القائد ظلّ صامتًا، يكتب الصلح بيدٍ ثابتة،
لأنه كان يسمع صوتًا أعلى من صوت سهيل،
صوت الوحي الذي لم يتكلم بعد.
اشتعلت الأسئلة في القلوب،
وارتجف الإيمان أمام لحظة الامتحان،
لكن الوحي نزل من السماء يبدّد كل غيمٍ من الشكّ:
“إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا.”
لم يكن الصلح هزيمة، بل فتحًا مؤجّلًا.
لم يفهمه الناس يومها،
لكنهم أدركوا بعد عامين أن النصر لا يحتاج ضجيجًا،
بل بصيرةً ترى الفجر قبل أن يطلع.
وفي فجر الفتح،
عاد النبي ﷺ إلى مكة لا فاتحًا بسيف، بل بسلامٍ يحمل هيبة النبوّة وعدل الرسالة.
جيش الإيمان يسير في أربعة كتائب منظّمة،
يدخلون من مداخل متفرّقة من مكة بأمرٍ من النبي ﷺ،
حتى لا تُراق دماء ولا تُروَّع قلوب.
رفع راية القيادة في يده،
وقال للناس بأمرٍ يُكتَب بماء الرحمة والعزّة معًا:
“من دخل دار أبي سفيان فهو آمن،
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن،
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.”
كانت كلماتٍ تفتح القلوب قبل الأبواب،
لكنها كلماتُ المنتصر الذي يملك القرار،
رحمةُ القوة لا ضعف، وعدلُ الغلبة لا خوف.
ولمّا اقتربت إحدى الكتائب من جهة الخندمة،
وقع اشتباكٌ بسيط مع بعض شباب قريش الذين ظنّوا أن النصر يُدفع بالسيوف،
لكن النبي ﷺ أوقف القتال فورًا، وقال:
“كفّوا عنهم، فإنّ اليوم يوم رحمةٍ بعد غلبة،
ورحمةُ المنتصر أهيبُ من بطشه.”
فسكن الغبار، وخمد صوت الحديد،
ودخلت مكة على وعدٍ جديدٍ من السلام.
وقف القائد في المسجد الحرام،
وأهل مكة بين يديه صامتون ينتظرون الحكم،
وفي عيونهم خوف الماضي وظلال الهزيمة.
نظر إليهم النبي ﷺ بعينٍ جمعت القوة والرحمة، وقال:
“يا معشر قريش، ما ترون أني فاعلٌ بكم؟”
فأجابوه وقد خفّت أصواتهم:
“خيرًا، أخٌ كريم، وابن أخٍ كريم.”
فقال ﷺ بصوتٍ ثابتٍ يفيض عدلًا وعفوًا:
“اذهبوا فأنتم الطلقاء،
عفوٌ لا خوفًا، بل قوةٌ تعرف أن الحق إن ظفر، لا ينتقم بل يُطهّر.”
ثم دخل المسجد الحرام،
وفي يده قوسٌ صغيرة،
يتقدّم نحو الأصنام التي لطّخت الكعبة دهورًا طويلة،
يضربها بيده المباركة وهي تتساقط واحدةً تلو الأخرى،
وهو يقول بصوتٍ يملأ مكة نورًا وهيبةً:
“جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقًا.”
تهاوت الأصنام كأنها رموزٌ لكل باطلٍ في كل زمان،
وغمر النور أرجاء الكعبة،
ليعلن أن الحقيقة لا تموت، بل تنتظر وقتها لتتكلم.
ثم تكرّر المشهد بعد قرون،
حين سار رجلٌ من نسل البطولة على خُطا النبوّة،
صلاح الدين الأيوبي،
الذي دخل القدس لا متعاليًا بسيفه،
بل خاشعًا كمن يؤدي صلاة شكرٍ على وعدٍ تحقّق بعد طول انتظار.
لم يرفع راية الانتقام،
بل رفع راية العدل،
وأمر أن تُطهّر المدينة من الدم لا به،
وأن يُؤمَّن أهلها مهما اختلف دينهم،
كما أمَّن النبي ﷺ أهل مكة يوم الفتح.
كان صلاح الدين يدرك أن الأرض تُحرَّر مرتين:
مرةً من العدوّ،
ومرةً من الكراهية التي يزرعها العدو في القلوب.
وهكذا وحّد بين السيف والعفو،
كما وحّد النبي ﷺ من قبله بين القوة والرحمة.
وهكذا تعلّمنا من الحديبية والقدس معًا أن السيوف قد تصمت،
لكن الوحي لا يسكت.
وأن القائد الذي يرى بنورٍ من الله،
قد يُلام اليوم… ليُفهم غدًا.
ففي كل عصرٍ باطلٌ يعلو حينًا ثم يزول،
وحقٌّ يختبئ في الصبر حتى يُؤذن له بالظهور.
وحين يتكلم الحق، يصمت كل شيء…
ويبدأ الفتح.