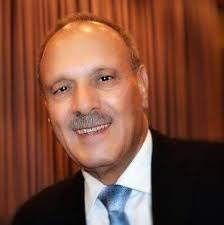ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد

ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: خطبة الوداع
تحيّة طيبة وبعد،
الهدوء يملأ المكان.
السماء فوق عرفات صافية،
وأشعة النور تتسلل على وجوهٍ بيضاء ترتدي لباس الإحرام.
الصحابة واقفون في خشوعٍ عميق،
عيونهم تحدّق نحو المنبر، وقلوبهم تبكي قبل أن تبكي العيون.
الريح ساكنة،
الجبال خاشعة،
الملائكة كأنها تسمع…
وأشرف خلق الله ﷺ يقف بينهم،
وجهه يشرق نورًا، وصوته يملأ الأفق:
«ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.»
كانت تلك اللحظة التي توقّف فيها الزمن.
النبيّ لا يتحدّث فقط إلى من حوله،
بل إلى كلّ من سيأتي بعدهم — إليّ وإليك،
إلى كلّ قلبٍ سيقرأ كلماته بعد أربعة عشر قرنًا،
ويشعر كأنه حاضر في عرفات الآن.
في التاريخ لحظات لا تتكرّر،
ولعلّ أعظمها تلك التي وقف فيها النبي محمد ﷺ فوق جبل الرحمة في عرفات،
ينظر إلى أمّةٍ لم تعرف بعدُ حجم الأمانة التي حملها لها،
ويقول بصدقٍ يقطر نورًا ودمعًا:
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
تلك الكلمات لم تكن ختام خطبةٍ عادية،
بل كانت ختم الرسالة،
وخاتمة البلاغ الإلهي للإنسان في رحلته بين الطين والسماء.
في تلك اللحظة، كان كلّ شيءٍ في الكون يصغي:
الريح ساكنة، والجبال خاشعة، والقلوب بين خوفٍ ورجاء.
كان الصحابة يبكون بصمت،
كأن كلّ دمعةٍ منهم توقيعٌ على بيعةٍ أبديةٍ مع الله ورسوله وآل بيته الطاهرين.
كانوا يسمعون بقلوبهم قبل آذانهم،
ويرون بنور اليقين قبل أن تلامس أعينهم المشهد.
السكينة تعمّ المكان،
والنور يزداد إشراقًا كلّما ارتفع صوته ﷺ:
إني تاركٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبدًا:
كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.
عندها نظر الصحابة إلى بعضهم بدهشةٍ ممزوجةٍ بالرهبة.
فهموا أن هذه ليست وصيّة وداعٍ فحسب،
بل عهدٌ أبديّ بأنّ الدين لن يبقى حيًّا إلا بالقرآن وأهل البيت.
فطأطأوا رؤوسهم إجلالًا،
كأن كلّ واحدٍ منهم يردّد في سره:
«بلغتَ يا رسول الله، فشهد الله علينا أننا آمنا بك وبما جئتَ به.»
بهذا الربط بين الكتاب والعترة،
أراد النبي ﷺ أن يقول للأمة إنّ الدين لا يُختصر في النصوص،
بل يُكتمل بالقدوة،
وأنّ النور لا يُحمل باللسان فقط، بل بالقلب والعقل والعمل.
يا قارئ هذا المقال،
تأمّل كم تشبه تلك اللحظة ما نعيشه اليوم.
الرسول ﷺ سلّم الأمة “الوعي”،
فحوّلناه إلى “جدل”،
وأوصانا بالرحمة،
فتحولنا إلى فرقٍ تتناحر باسمها.
لقد قالها ﷺ بوضوح:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.»
لكنّ التاريخ أثبت أنّ أكثر ما أُريق بعده هو الدم،
وأكثر ما نُهبت هي الأموال،
وأكثر ما انتُهكت هي الأعراض،
وأنّ الإنسان ما زال يعيد ذات الخطأ…
نسخةً بعد نسخة.
ثم يلوم نفسه حتى مماته .
حين قال ﷺ:
«ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد»
كان يسجّل لحظةَ الوعي الكامل،
ويضع أمام البشرية مرآةً صافية لا تُزوّر.
فهو لم يطلب شهادة الناس،
بل شهادة الله.
لم يسعَ لتصفيق الحشود،
بل لإبراء ذمّته أمام خالقها.
ومن يومها، صارت هذه العبارة مقياسًا لكلّ من يتكلّم باسم الحق:
هل بلّغت؟ وهل كانت نيتك لله؟
اليوم، وبعد أربعة عشر قرنًا،
ما زال السؤال نفسه مطروحًا علينا:
هل بلّغنا كما بلّغ هو؟
هل حافظنا على ما أوصى به من وحيٍ ورحمةٍ وعدلٍ؟
أم سلّمنا الرسالة لشاشاتٍ تصرخ بدلاً من أن تبصر،
ولأقلامٍ تكتب من أجل الجاه لا من أجل الله؟
في زمنٍ صار فيه الكذب أداة إعلام،
والفتنة تُسوَّق كحقيقة،
يصبح تكرار هذه العبارة واجبًا أخلاقيًا:
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
إنها ليست جملةً تُقال بعد الكلام،
بل ضميرًا يُقال قبل كل كلام.
إنها الميزان بين النية والنتيجة،
بين الصدق والزيف،
بين من يحمل الرسالة… ومن يبيعها.
لقد علّمنا النبي ﷺ أن الرسالة لا تُقاس بعدد الأتباع،
بل بصدق البلاغ،
وأنّ الحقّ لا يحتاج إلى ضجيجٍ ليثبت وجوده،
بل إلى من يرفعه بسكون.
من هنا، يجب أن ندرك أن حفظ الدين ليس في ترديد النصوص،
بل في التمسّك بروحها:
في الرحمة، في العدل، في محبة الله والنبي وآله الطاهرين،
وفي إدراك أن الإنسان ما خُلق ليُعاد في نسخٍ من الغفلة،
بل ليكون شاهدًا لا تابعًا.
فيا من تقرأ هذه الكلمات،
إن كنت في أمنٍ وأمان،
فما زال لديك فرصة الإدراك.
أكتب تاريخك بيدك،
ولا تسمح لأحدٍ أن يكتبه عنك.
واجعل آخر ما تهمس به في ضميرك،
قبل أن تقول أي كلمة أو موقف:
ألا هل بلغت؟
اللهم فاشهد… اللهم فاشهد… اللهم فاشهد.